خالد أخازي: ناقد ـ المغرب
«الساخر لا يضحك لأنه سعيد، بل لأنه الوحيد الذي ما زال يرى»
تعلن مجموعة «شيطان أخرس» عن نفسها بقسوة ماتعة، وصدمة فاتنة، وتمرد جريئ على الواقعية الأدبية الفجة، وعلى تنميط الأشكال الحكائية، كأنها ليست مجرّد عمل قصصي، بل بيان أدبي ساخر ضدّ الخضوع… تعدك بلذة النص، مقابل زلزال عقلاني يعري اليقين السياسي في تحولاته السريالية… تمتع لكنها… تقسو على التفاهة ومكر السلطة، روّاد العوّام بروح فنان يعرف أن الضحك لا يغيّر العالم، لكنه يفضحه.
في هذه المجموعة، تتحوّل اللغة إلى مرآةٍ مشروخة تعكس القبح المألوف، وتستبدل الوعظ بالنكتة، والمأساة بالسخرية.
أما الأرض التي تجري فيها الأحداث — إمبراطورية طزستان — فهي رمز شامل: بلادٌ متخيلة تُشبه كلّ ما نعرفه ولا نجرؤ على تسميته.
من خلال هذه البلاد الرمزية، يرسم الكاتب بانوراما للواقع العربي في أقصى عبثه:
حزب يطالب بالتغيير ليبقي على نفسه، مثقف يُسجن لأنه يتكلم، إعلام يحوّل الحقيقة إلى برنامج ساخر، ودولة تفسّر الزواج بلغة البروتوكول الأمني.
أولًا: “لا بد من التغيير” — عبث الشعارات ومسرح السلطة
تُفتتح المجموعة بهذه القصة التي تختزل العالم الطزستاني كله في مشهدٍ واحد: اجتماع الحزب الحاكم الذي يصرخ فيه الجميع: «لا بدّ من التغيير!».
لكن المفارقة أن الصراخ يتحوّل إلى شجارٍ جسدي بين القادة، قبل أن ينتهي الاجتماع ببيانٍ رسمي يعلن بقاء القيادة نفسها.
القصة تقوم على تكرارٍ دائريّ عبثيّ يذكّرنا بمسرح بيكيت وعبث الماغوط، حيث تتحول الكلمات إلى أصواتٍ بلا معنى.
الشعار السياسي يُفقد لغته تدريجيًا ليتحوّل إلى نعيق، واللغة التي كان يُفترض أن تغيّر الواقع تتحوّل إلى أداةٍ لتثبيته.
رمزية القصة لافتة: “التغيير” يصبح تميمة تُردّدها الطبقة الحاكمة لتخدير الوعي.
وهكذا تُفتتح المجموعة بإعلانٍ مبطّن:
«من هنا يبدأ الصمت العظيم الذي يُسمّى الكلام.»
ثانيًا: “لا تقرأ الماغوط وتنام” — الجنة البيروقراطية والحرية المحرّمة
هنا ينتقل الكاتب من سخرية السلطة إلى سخرية الميتافيزيقا.
يحلم الراوي ببابين: أحدهما أزرق كالزمرد، يقود إلى “أرض الراحة والسلام”، والآخر أسود قذر يقود إلى “أرض التعب”
يختار الباب الجميل، ليكتشف أنه جنة بلا حرية: لا كتابة، لا موسيقى، لا نساء، لا خمور، لا انفعال.
إنها يوتوبيا مشلولة تُحاكي الجحيم.
القصة تنتمي إلى السريالية الرمزية: عالم الحلم يصبح أداةً لتحليل الواقع العربي المقموع، حيث كلّ ما يُمنع في الواقع يُمنع أيضًا في الخيال.
حين يستيقظ البطل، يغنّي لبلاده: «كم أنت رائعة يا أرض التعب» — جملة تهزّ المفارقة حتى ذروتها، إذ يتحوّل “التعب” إلى موطن الحرية، و“السلام” إلى سجن مقدّس.
هنا يبلغ الكاتب ذروة فنيّة:
السخرية ليست ضد الدين أو الأخلاق، بل ضدّ الطهر الزائف الذي يصادر حقّ الإنسان في أن يكون إنسانًا.
ثالثًا: “شيطان غير أخرس” — مأساة المثقف في زمن القطيع
في هذه القصة يقدّم روّاد العوّام شخصيةً من أكثر ما كتب صدقًا ووجعًا.
بطل القصة مثقفٌ ساخر يرفض الصمت، يتنقّل بين السجن والمدرسة والمقهى، يصطدم بالنفاق في كلّ مكان، ويقول بمرارة:
«أنا شيطان لا يعرف الصمت.»
العنوان وحده مفتاح الرؤية: الشيطان في ثقافتنا رمز العصيان، لكنه هنا رمز الوعي والكرامة.
المثقف “الشيطان” يُسجن لأنه صرخ في الملعب ضدّ منتخبٍ فاسد، فاتهموه بإهانة الوطن!
ثم يُعتقل لأنه كتب شعارات ضدّ الفساد، لكن الناس أنفسهم يطالبونه بتغيير الشعارات وفق “الأصول”، فيكتشف أن الشعب والسلطة يلتقيان في عبودية واحدة.
القصة مرآة مؤلمة للثقافة العربية التي تكره الصوت الحرّ، وتحب المثقف المروّض.
إنها تراجيديا عقلٍ يُكافَأ بالعقاب لأنه لم يخضع.
وفي عمقها، صرخة روائية تقول:
“الخرس جريمة، والجنون آخر أشكال الصدق.”
رابعًا: “أنت لا تفهم التوازنات” — البنية الأبوية للدولة والمجتمع
من أعظم قصص المجموعة من حيث البناء والحوار والتكثيف.
الحكاية بسيطة في ظاهرها: أب وابنه يخططان لحفل زفاف.
لكن الأب يحوّل قائمة المدعوّين إلى خريطة كاملة للسلطة الطزستانية: الأمن، الحكومة، رجال الدين، الاقتصاد، وحتى “المفاتيح الخفية”.
الزفاف يتحوّل إلى مؤتمر وطني.
الابن، الذي أراد زواجًا إنسانيًا بسيطًا، يُرغَم على كتابة بطاقات دعوة وفق بروتوكولٍ معقّد يعكس تشابك الفساد في كلّ المستويات.
القصة حوار طويل يُشبه مقطعًا مسرحيًا محكمًا، تُستعمل فيه اللغة كمِشرطٍ سياسيّ.
الأب يكرّر: «أنت لا تفهم التوازنات»، وهي الجملة التي تختزل منطق السلطة العربية:
الطاعة ليست خوفًا بل “توازنًا”، والفساد ليس عيبًا بل “عرفًا اجتماعيًا”.
في خلفية النصّ تتجلّى رمزية الدولة الأبوية: الأب هو الحاكم، الابن هو المواطن، والزفاف هو المشهد الوطني الدائم حيث تُوزَّع الأدوار لا الحصص من الفرح.
هذه القصة هي قمة المجموعة من حيث النقد البنيوي للسلطة، فهي تحوّل الحياة اليومية إلى استعارة للدولة، وتكشف أن الاستبداد ليس مؤامرةً من فوق، بل عادةً من تحت.
خامسًا: “لستُ معاديًا للدولة!” — اعترافات المواطن المطيع
في هذه القصة القصيرة المكثفة، يُقدّم العوام مشهدًا ساخرًا لمواطن يبرّر خوفه من السلطة بحجة الولاء.
النصّ يُكتب بلسانٍ يختلط فيه الإيمان بالجبن، فيتحوّل الدفاع عن الوطن إلى دفاع عن الظلم.
إنها مفارقة فكرية دقيقة: كيف يصبح الولاء غطاءً للخرس، وكيف يتحوّل الانتماء إلى انصياع.
تستحضر القصة نغمة المونولوج الاعترافي، كأنها محاكمة داخلية لعقلٍ مشلولٍ بالخوف.
سادسًا: “يا أخي، يا حبيبي” — العشق المستحيل بين المواطن والسلطة
نصّ ساخر يتخذ شكل خطاب مزدوج، يتناوب فيه النداء العاطفي والشتيمة.
تعبّر القصة عن علاقة مرضية بين الشعوب وحكّامها، علاقة تقوم على التبعية والرغبة، الكراهية والحاجة.
الكاتب يجعل من النداء العاطفي (“يا أخي، يا حبيبي”) قناعًا للغضب المكبوت، فكل جملة حنان تنطوي على لعنةٍ مضمرَة.
إنها حكاية الحبّ المستحيل بين المواطن والمستبدّ، حبّ قائم على الإهانة والتواطؤ.
سابعًا: “موت الرقيب” — انهيار المؤسسة الثقافية
هنا تبلغ السخرية من المشهد الثقافي العربي أقصى درجاتها.
في اتحاد كتّاب طزستان، يموت الرقيب فجأة، فيتوقف الكتّاب عن الكتابة لأنهم لا يعرفون ما يُسمح به وما لا يُسمح.
المفارقة قاتلة: الحرية تخيفهم أكثر من الرقابة.
النصّ يجعل من موت الرقيب استعارةً لموت الضمير الإبداعي، ويكشف أن الرقابة الداخلية أخطر من الخارجية.
إنها سخرية فكرية سوداء تصيب الثقافة العربية في مقتل.
ثامنًا: “حذاء زمردة” — الإعلام كحكاية تزييف
في هذه القصة التي تدور في تلفزيون طزستان، تتحوّل البرامج إلى مسرحيات كذب متقنة.
المذيعون لا ينقلون الحقيقة بل يصنعونها، والزيف يصبح نوعًا من “الفن الرسمي”.
الكاتب يوظّف المفارقة والتهكم على اللغة الإعلامية ذاتها، فتبدو العبارات المكرورة (الشفافية، الصدق، الإنجاز…) كأنها تعاويذ ضدّ الحقيقة.
القصة لا تهاجم الإعلام فحسب، بل تعرّي اللغة كمؤسسة قمع.
تاسعًا: “أيقونة أثرية” — عبث الهوية والتاريخ
هنا يسخر العوام من استغلال الماضي وتقديس الرموز.
القصة تسائل ذاكرة الأمة التي تلمّع رموزها القديمة بينما تُهمل حاضرها الميت.
يستعمل الكاتب رمز “الأثر” ليشير إلى عقلٍ يعيش في متحف، ويقدّم التاريخ كصنم يُعبد بدل أن يُفهم.
التهكم هنا فلسفي عميق: الماضي ليس مجدًا، بل قيدًا مزيّنًا.
عاشرًا: “كل أيامي سعيدة” و”نظرية الأعلام” و”مثلي تمامًا” — الخاتمة الساخرة للعبث العام
في هذه القصص الأخيرة، يتخفف الكاتب من الحبكة ليتفرّغ للرمز الكلي.
في “كل أيامي سعيدة”، يتحدّث موظف وزارة الإعلام بلسان من يُجبر على الفرح، حتى تصبح السعادة واجبًا وطنيًا.
وفي “نظرية الأعلام”، يسخر الكاتب من التحليلات الفارغة التي تبرّر الخراب بلغة أكاديمية.
أما “مثلي تمامًا”، فهي مرآة الذات الأخيرة، حيث يواجه الكاتب نفسه ويقول عبر شخصية رمزية: “أنا مثلك تمامًا، أسخر كي لا أموت.”
بهذه الخاتمة، تكتمل الدائرة: من “لا بد من التغيير” إلى “مثلي تمامًا”، ينتقل النص من جماعية الخديعة إلى فردية الوعي، من القطيع إلى الذات.
اللغة والأسلوب
لغة العوام هجينة نابضة: تزاوج بين العامية والفصحى، بين التقريرية الشعرية والتقرير السياسي، لتصنع لغة ثالثة ساخرة.
إنها لغة “الوعي المقهور”، تقطر مرارةً، وتُحافظ على حرارة الحوار الواقعي.
تستخدم المفارقة بدل الجملة الوعظية، والمشهد بدل الخطبة.
الكاتب يخلق أسلوبه لا بتزيين العبارة، بل بتشويهها لتقول الحقيقة.
جمالية الحكي عند روّاد العوّام تقوم على التنافر الواعي بين السخرية والوجع. فالكاتب يجعل من المفارقة جمالًا، ومن العبث شعرًا، ومن الضحك موقفًا أخلاقيًا…. ويعتمد على التكثيف اللغوي، إذ تُختزل الفكرة الكبرى في جملة صغيرة لاذعة، وعلى اقتصاد السرد الذي يخلق إيقاعًا داخليًا متوترًا….عنده كل قصة تنبض بجمال “اللاانسجام”، حيث الجملة الهادئة تخفي انفجارًا، والمشهد الكوميدي يلمع كمرثية.
إنها شعرية القبح الجميل، حيث الفن لا يزيّن الواقع بل يعرّيه بجرأة… وتتمثل جمالية الدلالة في ثراء الرمز واتساع أفق التأويل، فالكاتب يبني رموزه على نحو دائري متكامل:
طزستان رمز السلطة المريضة والمجتمع المطيع…. الشيطان غير الأخرس رمز المثقف الذي يرفض الصمت.
الزفاف في “أنت لا تفهم التوازنات” رمز العلاقة الملتبسة بين المواطن والنظام الأبوي.
موت الرقيب رمز الثقافة الخائفة من الحرية
بهذه الرموز المتراكبة، تتحول القصص إلى قراءة فلسفية في الوعي الجمعي، لا في الأحداث وحدها…القوة الدلالية هنا في عمق البساطة: الفكرة تُقال ضاحكة، لكنها تترك أثرًا دامٍ في الوجدان.
أسلوبيا تفوق العوام على السردية التقليدية، حيث يتميّز أسلوبه بـ بلاغة السخرية وموسيقى الحوار، ويكتب بجمل قصيرة، متقطعة، مشحونة بإيقاع نفسي داخلي، موظفا التكرار كأداة نقد، فيحوّل اللغة الرسمية إلى مادة تهكم والحوار عنده درامي الصياغة، نابض بالتصادم الطبقي والفكري، يفضح منطق السلطة والجهل.
بمزج بين الفصحى والعامية بذكاء، ليخلق لغة هجينة تمثل صوت المواطن المقهور لا صوت الكاتب وحده، هكذا تتحول اللغة إلى بطلٍ من أبطال النص، تتكلم وتختنق وتصرخ، لتجعل القارئ يسمع وجعها قبل أن يفهم معناها.
القوة في «شيطان أخرس» لا تكمن في القصة كحكاية، بل في السخرية كوعيٍ فنيّ مقاوم
النصّ جميل لأنه صادق، رمزي لأنه إنساني، ساخر لأنه يرى ما لا يُرى….إنها كتابة تُحوِّل القهر إلى فن، والصمت إلى صوت، والضحك إلى سلاحٍ نبيل ضدّ الخضوع. .. .
«شيطان أخرس» ليست فقط مجموعة قصصية؛ إنها مختبر لبلاغة المقاومة.
فيها تُستبدل الفلسفة بالنكتة، والخوف بالضحك، واليأس بالوعي.
الكاتب لا يهاجم السلطة وحدها، بل يواجه الخرس الجماعي الذي جعل من الصمت فضيلة.
كل قصة هي مرآة صغيرة في لوحة كبرى، تنتهي جميعها إلى حقيقة واحدة:
«الساخر لا يضحك لأنه سعيد، بل لأنه الوحيد الذي ما زال يرى.»
بهذه الرؤية، يرتقي روّاد العوام بالسخرية من الهزل إلى الفلسفة، ومن الضحك إلى فعل مقاومة رمزية ضدّ العبث والرضوخ.



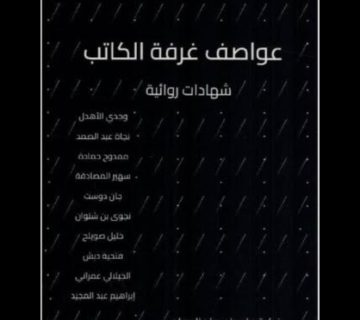
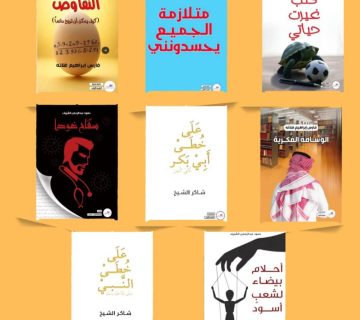

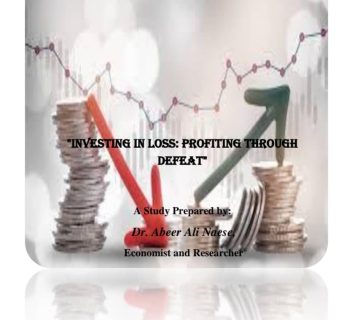
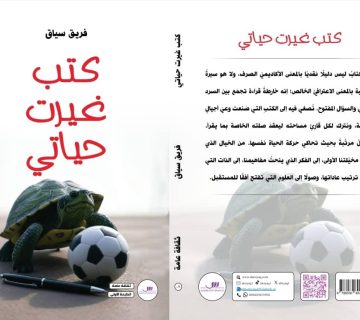

لا تعليق